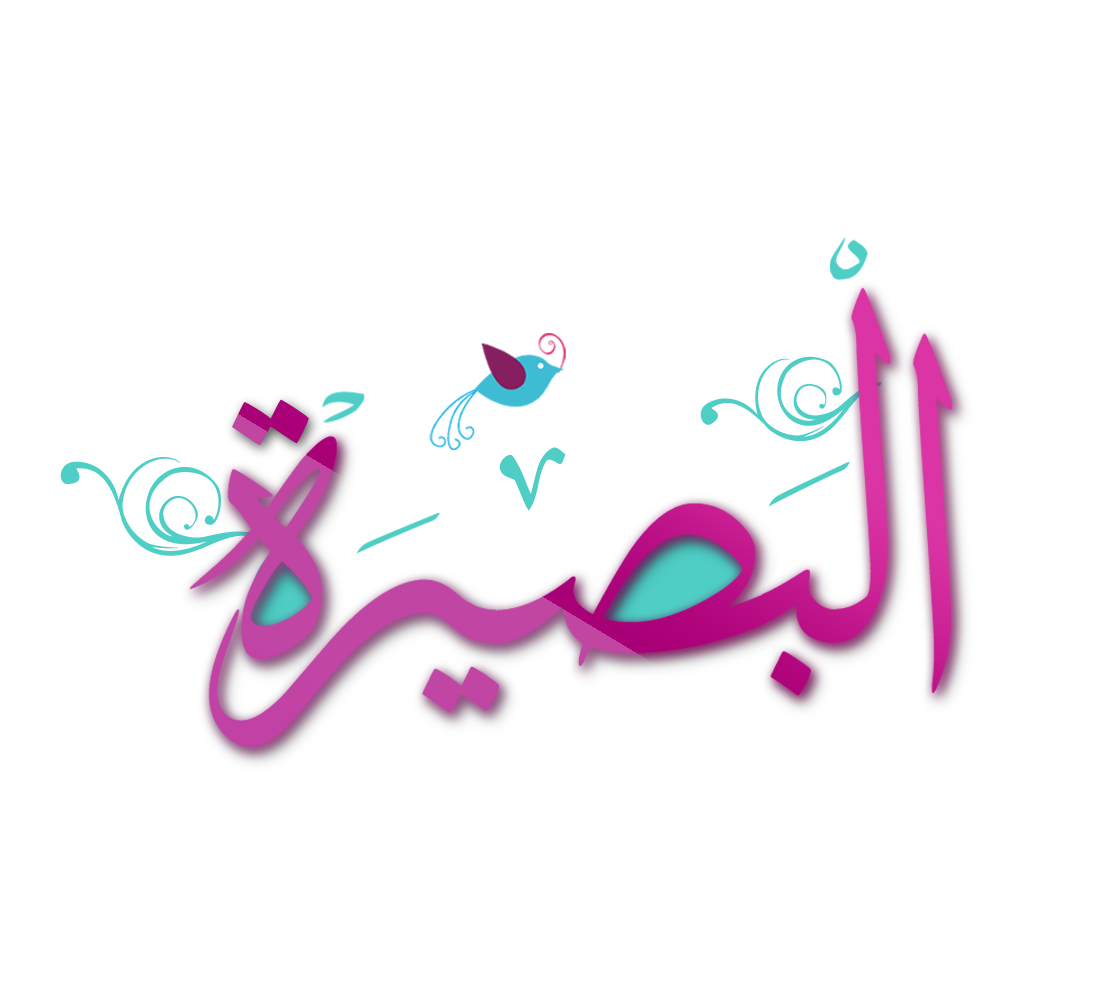الإيمان بالاستواء على العرش وعلو الذات والفوقية له أهمية عظمى في فهم توحيد الربوبية، وإفراد الله عز وجل بالخلق وتدبير الأمر، فالمعطلة الذين نظروا إلى إثبات الاستواء نظرة ضيقة باطلة من خلال قياسهم الخالق على المخلوق بقياس تمثيلي أو شمولي، تصوروا أن ظاهر النصوص الواردة في إثبات حقيقة استواء الرحمن على عرشه، هو بعينه ما يصدق على استواء الإنسان على عرش، وبسبب هذه النظرة الباطلة زعموا أن ظاهر النصوص يدل على التشبيه والجسمية، ولا بد من تعطيله وتأويله بأي وسيلة كلامية، فقالوا في الاستواء، استيلاء وقهر، وجمعوا بين الظن السيئ في كلام ربهم وتعطيلهم له، إذ فهموا كلام الله عز وجل على غير مراده، واعتقدوا فيه التمثيل، ثم حرفوا الكلم عن مواضعه بالتأويل الباطل، واعتقدوا في النصوص التعطيل.
وإذا كانت قضية الاستواء وإثبات علو الذات والفوقية قد أخذت جهدا كبيرا في دفع شبهات المبتدعة وآرائهم العقلية، وإثبات ما دلت عليه الأصول القرآنية والنبوية؛ فإنه من الأهمية بمكان تناول قضية الإيمان بعلو الذات والفوقية من جانب توحيد الربوبية، حتى يظهر مدى التوافق في العقيدة السلفية بين إيمانهم بتوحيد الأسماء والصفات من جهة، وتوحيد الربوبية من جهة أخرى.
وبيان ذلك إن ملوك الدنيا مع أن ملكهم محدود زائل, واستحقاقهم للملك إنما هو من الله الملك الحق، منة منه لهم على سبيل الأمانة والابتلاء، والاستخلاف والاسترعاء, فهو سبحانه الذي يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، إلا أن ملوك الدنيا يبالغون في الحفاظ على عروشهم، ويجعلون قصورهم في الأماكن المرتفعة فوق الماء, ويفتخر كل منهم بأنه صاحب العرش والسلطة والقوة والهيمنة، فأعلاهم استكبارا الطاغوت الأكبر إبليس، لما نزل هذا الخبيث إلى الأرض، نصب لنفسه عرشا على الماء؛ ليتشبه باستواء الله على عرشه في السماء، بحيث يكون هو المعبود بالباطل والشرك في مقابل المعبود بحق، فجعل نفسه إلها لأتباعه ومن على شاكلته، وقرب إليه من كان من حزبه وطريقته.
روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: (إِن إِبْليس يضعُ عرْشهُ على الماءِ، ثمّ يبْعثُ سراياهُ، فأدْناهُمْ مِنهُ منزِلةً أعْظمُهُمْ فِتْنةً) ( ) .
وقد أصبح الشيطان رأس الطواغيت، ومؤسس سبل الطغيان، لكل ملك ظالم من بني الإنسان، قال تعالى: الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا /النساء:٧٦.
والإنسان في دار الابتلاء بالخيار بين عبودية الملك الحق الذي استوى على عرشه فوق الماء في السماء، وعبودية الطاغوت أو الشيطان الذي نصب عرشه على الماء في الأرض.
ومن عظمة العرش ودلالته على إثبات الملك, أن العرش ذكر في سورة النمل في قصة سليمان مع الهدهد ست عشرة مرة, فكل ملك من الملوك يتخذ لنفسه عرشا عظيما يدل على منزلته وقدره, فشتان بين عرش وعرش، وقد فرق الهدهد بين عرش بلقيس وعرش الرحمن.
وإذا كان هذا حال ملوك الدنيا في حماية عروشهم وقصورهم ووضعها في الأماكن المرتفعة على الماء، وهم يعدون ذلك كمالا في حقهم، فإن الله عز وجل الذي وهب الكمال لخلقه أولى أن نؤمن بما أثبته لنفسه في علوه على خلقه، واستوائه على عرشه، وما وصف به العرش من أنواع الكمال اللائق بعرش رب العزة والجلال.
وقد وصف عرشه بالعظمة في مقابل تولي الخلق وكفرهم، فهو رب العرش العظيم، لأنه لما كان الاستواء على العرش دليلا على تولي أمور الملك، فلو أعرض الناس عن ملِك من ملوك الدنيا خلعوه من عرشه، ونصّبوا غيره، لأنه ما وصل إلى الملك إلا بهم، سواء بانتخاب أهله وعشيرته، أو حزبه وجماعته، أما ملك الملوك لو أعرض عنه سائر الخلق فالزوال لهم والبقاء لله وحده.
وملك الملوك على عرشه لا يأمر إلا لمصلحة تعود على رعيته، لأنه غني كريم عزيز رحيم، محسن إلى عبده لعلمه أنه فقير بذاته، وأنه لا غني لذاته إلا هو سبحانه، ومن ثم يريد به الخير، ويكشف عنه الضر، لا لجلب منفعة إليه من العبد، ولا لدفع مضرة، بل رحمة منه وإحسانا، ولطفا وإنعاما، ولهذا كانت جميع أوامر الله خير للإنسان، ولا يكون شر فيها أبدا، كما ورد عند مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (لبّيْك وسعْديْك، والخيْرُ كُلهُ فِي يديْك، والشّرُّ ليْس إِليْك) ( ) .
أما ملوك الأرض فلو أمروا بأمر، فالغالب على أوامرهم مراعاة مصالحهم قبل مصالح رعيتهم، وقضاء حاجاتهم والثناء عليهم قبل تحقيق مطالب رعيتهم، فالملك الرب من فوق عرشه إنما يريد الإحسان إليك لا لمنفعته، ويريد دفع الضرر عنك، فكيف لعاقل أن يعلق أمله ورجاءه وخوفه بغير الله. وإذا كان ملوك الدنيا يبادرون المخالف بالعقوبة فور وقوع المخالفة، وربما يحاسبونه قبل وقوعها بقانون الطوارئ والاشتباه، بل ربما يظل الإنسان مسجونا ظلما بغير ذنب وينتظر العفو بغير جدوى، أما ملك الملوك القدير من فوق عرشه حكيم في صبره على أذى رعية، كما روى البخاري من حديث أبى موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (ليْس أحدٌ أصْبر على أذى سمِعهُ مِن الله، إِنهُمْ ليدْعُون لهُ ولدًا، وإِنهُ ليُعافِيهِمْ ويرْزُقُهُمْ) ( ) .
قال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ الشورى٢٥.
ومن أعجب ما يرى المرء ما يحدث من أمور الشرك، والله عز وجل من فوق العرش يصبر على المشركين ويعافيهم ويرزقهم، فربما تجد من بعض الرعية من يتركون عبادة الملك الجبار رب العزة والجلال، ويشركون معه غيره، أو يعبدون المخلوق على سبيل الاستقلال، ويهتفون باسمه في الغدو والآصال، ويسألونه قضاء حوائجهم، بل يعتقد بعض المغالين منهم أن بعض الأولياء هو المتصرف في الكون، والمدبر له في كل حال، وقد ضربوا عليهم القباب وزخرفوها، وحبسوا عليها العقارات والأموال وأوقفوها، وجعلوا لها النذور والقربات، ووقتوا لها المواقيت زمانا ومكانا، وصنفوا فيها المناسك في حج المشاهد، وحجوا إليها أكثر مما يحجون إلى بيت الله الحرام، بل رأوها أولى بالحج منه، ورأوا من أخل بشيء من مناسكها أعظم جرما ممن أخل بشيء من مناسك الحج، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وإذا كان هذا شأن الملك فيمن عصاه، فكيف يكون شأنه ورأفته بمن أطاعه، إن الله عز وجل رفيق بعباده، قريب منهم، يغفر ذنوبهم، ويتوب عليهم، وهو الذي تكفل بهم من غير عوض أو حاجة، فيسر أسبابهم، وقدر أرزاقهم، وهداهم لما يصلحهم، فنعمته عليهم سابغة، وحكمته فيهم بالغة، يحب عباده الموحدين، ويتقبل صالح أعمالهم، ويقربهم، وينصرهم على عدوهم، ويعاملهم بعطف ورحمة وإحسان، ويدعو من خالفه إلى التوبة والإيمان، فهو الرفيق المحسن في خفاء وستر، يحاسب المؤمنين بفضله ورحمته، ويحاسب المخالفين بعدله وحكمته، ترغيبا لهم في توحيده وعبادته ليدخلوا في طاعته، والله رفيق يتابع عباده في حركاتهم وسكناتهم، ويتولاهم في حلهم وترحالهم، بمعية عامة، ومعية خاصة.